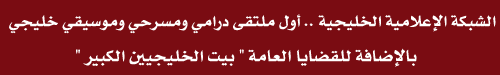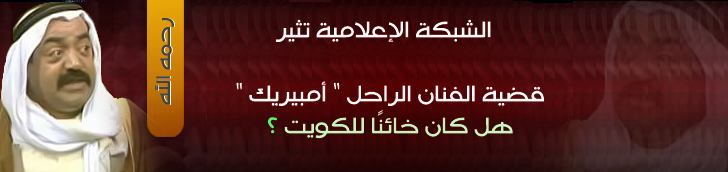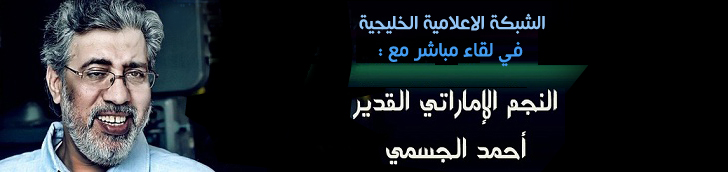| شبكة الدراما والمسرح الكويتية الخليجية > القاعات الكبرى > السلطة الرابعة ( الصحافة الفنية ) > كاتب روائع فيروز تحدث في لقاء نادر قبل وفاته مع بداية «غزو» النحول لجسده وظهور إشارات المرض عليه |
| البحث في المنتدى |
| بحث بالكلمة الدلالية |
| البحث المتقدم |
| الذهاب إلى الصفحة... |
 |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| | #1 (permalink) |
| إدارة الشبكة العــضوية: 5 تاريخ التسجيل: 30/07/2008
المشاركات: 11,505
| جوزف حرب روى حياته لـ «الراي» قبل رحيله: منذ الطفولة يراودني إحساس بأنه لم يبقَ لي وقت كاتب روائع فيروز تحدث في لقاء نادر قبل وفاته مع بداية «غزو» النحول لجسده وظهور إشارات المرض عليه قبل ثمانية أعوام ونيف، قرر الشاعر جوزف حرب التحرّر ممّا يهدر الوقت والاعتكاف في «صومعة» النظم؛ غادر بيروت وصخبها ولم يعد يزورها إلا في ما ندر أو لطباعة ديوان. في ركن داخل «قصره الجنوبي»، على أعلى تلة في بلدته المعمرية تطل على البحر والساحل القريب من صيدا، سكن في الظلّ، وتفرّغ للكتابة، الكتابة فقط؛ وجعل باكورة هذا «القهر الجسدي» الإرادي ديواناً، جاء من أضخم دواوين التراث العربي أسماه «المحبرة» (من نحو 1750 صفحة) أهداها للموت (2006). في المعمرية أقام جوزف حرب «في اللغة»، ومارس طقوس «مقارعة الموت» بالقصيدة والكلمة؛ ربما لأنه كان ينضح فوراناً فكرياً، يبحث له عن وقت إضافي، أو يحاول أن يوازن بين الزمن العادي وبين هذا الفوران، «فأخشى أن يكون هذا الفوران بحاجة إلى وقت أطول. أنا وقعت بتحد ربما أجج هذا الإحساس فيّ؛ هو أنني كتبت نصوصاً شعرية كاملة وليس مجموعة قصائد فقط». في هذا اللقاء غير المنشور الذي اجرته معه «الراي»، وكان النحول بدأ يغزو جسده إلى جانب بعض إشارات المرض (السرطان)، تحدّث حرب بتقطّع، وكان واضحاً أنه بدأ سباقاً مع الموت الذي أشار إليه أكثر من مرة، لافتاً إلى أنه يدور حوله، يقترب منه ويبتعد، ويشعر أحياناً بأن الصبح الأخير لن يدركه... لكن مرت 4 سنوات بعد هذا الحديث الذي لم يُنشر، ولم يعد هو بعد هذا اللقاء يتيح للصحافة أو الصحافيين الاقتراب منه، أو أنه لم يعد بعدها يستجيب لدعوة أو للقاء جماهيري مباشر... لقد أختار عزلته ليكتب بما تبقى له من وقت، حتى وافته المنية ليل الأحد - الاثنين في 10 فبراير 2014. من هو الشاعر جوزف حرب؟ الولادة والعائلة والنشأة؟ يقول حرب: «وُلدتُ العام 1944 في الناقورة قرب الحدود اللبنانية الفلسطينية، لأن والدي كان في الدرك، كان كل واحد منا، أنا وأخوتي، يولد في مكان خدمة الوالد العسكرية. مثلاً اختى وُلدت في صور، وأختي الأخرى في منطقة جبيل؛ وهذا سببه أن الدركي كانوا ينقلونه من منطقة إلى أخرى. والمنطقة التي قضينا فيها فترة طويلة في زمن الطفولة، هي منطقة جبيل وكنا في بلدة قريبة من دير القدّيس شربل، وعندما صارت هناك «خضة» حول القديس شربل، إذ لم يبل (يتحلل) جسده ووصلت القصة إلى روما، وبدأت قصة العجائب تظهر. في تلك الفترة كنا موجودين في منطقة جبيل؛ والمنطقة كونها عالية وفيها زهر وشجر كثيف ووديان مع طبيعة شرسة، والشتاء فيها أبيض لكنه كثير العواصف، هنا تشعر بأن عملية الجمر والموقد كانت حالة خلاص، وخصوصاً أننا ربحنا شيئاً من «ستّي» لأنها مرات كثيرة كانت تترك الضيعة هنا (المعمرية) وتذهب لتسكن معنا، كون والدي لا يمكنه أن يراها لفترات طويلة؛ وخلال وجودنا في جرود جبيل وضعنا والدي أنا وأختي بمدرسة داخلية عند الراهبات اليسوعية، راهبات القلبين الأقدسين في جبيل حيث بقينا 4 سنوات. في تلك الفترة بدأ عندي تكوين الأسئلة الأولى، كوني كنت الصبي الوحيد بالدير بين مجموعة كبيرة من البنات، لأن الراهبات ما كنّ ليقبلن في القسم الداخلي إلاّ البنات. كان ممنوعاً قبول الصبيان في هذا القسم. وفقط لأننا نأتي من بعيد ونحتاج إلى مسافة 40 كيلومتراً حتى نصل، قبلوني وجعلوني في غرفة واحدة مع أختي، وكان في الغرفة «برداية» تقسم الغرفة قسمين، وخلفها كان هناك سرير لراهبة. أذكر أنني في الليل كنت أدخل لعند الراهبة، وتوجد نافذة تطل على لمبة الكهرباء (المصباح) في الشارع. كنت أحتفظ معي بحصى وأرميها من النافذة محاولاً إصابة المصباح، وكل هذا لأنني دخلت مرة صدفة لعند الراهبة، وهي تبقى في سريرها دائماً، فاكتشفتُ أنها مريضة؛ وكانت تجمع لي الشوكولا وأطعمة وتعانقني مرات وتبكي بشكل أنّها حفرت فيّ صورة من المستحيل أن يستطيع الفرد ان ينساها. وصرت أحب أن يأتي الليل حتى أدخل وأقف خلف الشباك، وأحب كثيراً أن أصعد في النهار إلى غرفة النوم، كي أراها، ووراء ذلك أن عندها شوكولا. أحببتُها كثيراً وكانت بديلة عن أمي التي كانت إنسانة حنونة جداً، وإضافة إلى حنانها كانت مريضة في القلب منذ فترة طويلة. كنت بحدود سبع سنوات (1951) وماتت الراهبة لأنها كانت مريضة؛ وكتبت لها لاحقاً قصيدة في ديوان «شيخ الغيم وعكازه الريح». ويضيف حرب: «كان ثمة قداس كل يوم للتلامذة في القسم الداخلي، ولأنني كنت الصبي الوحيد، فأنا أخدم الخوري، وأنا أقرأ الرسائل. يومياً بعد الظهر، العصر، كانت هناك قراءات من كتب دينية، وصرتُ أتمرّن على النصوص وأقرأها في الأوقات التي يعطوننا إياها بحدود المساء، قبل العشاء. من هنا صارت علاقتي مع ما يسمى اللغة، وعلاقتي مع ما يسمى الطقس الكنسي الذي في خلفيته شاعرية تضاف إليه. هناك شيء من الرهبة التي لا توصف بالعلاقة مع الدين، خصوصاً بالنسبة الى جو الكنيسة، حيث نلاحظ ان القديسين غالبيتهم كبار في العمر وهذه دلالة على أنهم وصلوا إلى شيء من الحكمة. فبالاضافة إلى رائحة البخور والعتمة والشموع، ومن صور القديسين التي رسخت في رأسي، صار عندي نوع من عالم في الداخل، فيه شيء من عملية التفكير بأنه يجب ان يكون أحد آخر يحميك، وهذا الآخر، كان أمي. ولهذا السبب، كنا كلما نعود إلى البيت، أفكر غالبية الوقت بأننا سنعود إلى الدير. كنت أرى الخلاص في عملية رجوعنا إلى البيت، لأن أمي موجودة. والمشكلة أنه في بعض القراءات الدينية، كان هناك نوع من النصوص عن القديسين أو الله، وكيف يقاصصون مَن يخطئ. ومن جملة هذه الصور، بحر مليء بالدم الذي يتفور من كثرة وجود لهيب ونار، ومركب مثقوب ومجموعة من الشياطين يجذفون بأذنابهم، وأشكال الشياطين مع قرون ولهم أياد قريبة من أيدي القرود ووجوههم كوجه الذئب. هذه الصور، وأنت طفل، تحملها إلى سريرك، تغمض عينيك، تجرّب أن تنام ولا أحد إلى جانبك، فكان الملجأ في هكذا حالة، الاحساس بحضور أمي الذي كان كثيراً ما يغلب عليّ. لو أن الواحد يترك الدير نهائياً ويلجأ إلى أمه وليس إلى أبيه، لأن والدي كان يريد «الصرفة» أن يأتي مساء الأحد حتى نعود الى الدير اذ كانت عنده رغبة شديدة في أن نتعلم. وبحسب وضعه الشخصي، كان يعتبر أن العلم انتقام من الفقر، انتقام من شعورك أنك انت إنسان مرؤوس، وان عليك أن تنفذ الأوامر. فضلاً عن نوع من العذاب الطويل كان يقاسيه جراء نقله سنوياً من مكان إلى آخر، ما كان يضطره الى البحث عن منزل جديد للإيجار، وغالبية المناطق التي انتقلنا إليها كانت المدارس فيها إلى حد ما شعبية. إلى أن وصلنا إلى البترون، فكانت المدرسة فيها «الفرير» وسجّلنا داخلي كما قلت عند الراهبات في جبيل. وبعدها انتقلنا إلى بيروت وتحديداً المريجة، برج البراجنة، فسجّلنا في المعهد الأنطوني حيث درسنا القسم التكميلي والثانوي». ويتابع: «عندما رأيتُ البحر للمرة الاولى خفت. وكان ذلك حين صرنا في القسم الداخلي في جبيل، اذ كنت أعيش قبلها في الجبال حيث العواصف وأشجار السنديان والطرق الوعرة والوديان وغابات شجر لا توصف على قدر ما لها من أشكال، بالاضافة إلى الغيم الذي يبدّله الهواء كنحات، سريع التبديل، ولا يستقرّ مرّة على رأي. وحين أنزلونا إلى الداخلي وكان دير الراهبات قرب البحر، كان البحر من الأشياء التي أرعبتني جداً. بعدها عرفت أن هذا الغيم الذي يأتي إلى الجبل فوق، هو من البحر، فصرتُ أحب البحر. وكان الجو إلى حد ما متناقضاً بين أنك مسرور أو خائف، بين أنك مطمئن وقلِق. بالإضافة إلى ذلك، فترة الطفولة عند كل إنسان هي الفترة الوحيدة التي يشعر فيها بالحرية. لكن هنا، ما أن تصل إلى سنّ 6 أو 7 سنوات، حتى تبدأ أدوات القمع من المدرسة، من طرق التربية، من طرق التعليم، من العادات والتقاليد. وقبلها مهما فعلتَ، حتى لو كسرت أي شيء يضحكون لك، حتى أنهم يعلمونك كيف تشتم ويغشون من الضحك. وعندما تبدأ بترك طفولتك يصبحون يضربونك اذا تلفظتَ بالشتيمة ذاتها، او حتى اذا ارتكبتَ أخطاء في الإملاء أو جدول الضرب أو أي شيء آخر. وهنا تشعر بأنك انتقلت من حرية لا متناهية إلى قمع سريع وعنيف. وأعتقد ان هذا الجزء من فترة ما يسمى الحرية التي يملكها المرء طفلاً عبر حواسه الخمس، وليس عبر نضوجه الفكري، هي الفترة الوحيدة التي يتمتع فيها بحرّية كاملة، وهي الحالة الوحيدة التي ترافقه كل حياته وإلى حد ما تساعده على أن يكون عنده نوع ما من التحصين في سبيل أن يبقى حرّاً؛ وهذا أكثر ما يظهر عند ما يسمى الفنانون وعند الكتّاب خصوصاً لأنه لا يمكنك أن تكتب نصاً بحرية مجتزأة، فأنتَ تحتاج إلى حرية كاملة كي يمكنك التعاطي مع النص. هذه إلى حد ما، المرحلة التي كنت آتي فيها إلى الضيعة وكان هذا يحصل في الصيف. هنا في الضيعة نعيش حياة الأقارب. كانت ألعابنا متواضعة، الأحصنة قصباً، وكانت علب السردين هي السيارات، نضع فيها ركاباً من تراب أو بحص ونجرّها، وكانت الحمارة، الدّابة، وكانوا هنا يقتنون حمارة وليس حماراً، لأنها تنجب وتنتج، وكانت الدابة نوعاً من الأحلام، (سيارة) كاديلاك، رولز رويس، وكنا نركب على الدابة وننطلق بين الجلالي والحقول، يتملّكك نوع من الإحساس بالتغاء فكرة الأمومة والأبوة وأنك لا تريد العودة، لا إلى المدرسة أو إلى أي مكان، وأن بقاءك على ظهر هذه الدابة هو أجمل وأطيب ما قدمته لك هذه الحياة. وتروح بعدها إلى المدرسة، تمرّ أشهر والدابة في رأسك، لا دروس الأشياء ولا كتاب التاريخ ولا كتاب الجغرافيا ولا الحساب أو أي شيء، تغمض عينيك وتفكر (تتخيل) أنك راكب على الدابة وموغل في هذه الدفلى وبرك المي (الماء) وشجر الزيتون والطيون، وتنتقل بك من مكان إلى آخر. طبعاً لم يكن يوجد سيارات إلا ما ندر. بقينا تقريباً في هذا الجو إلى أن صار عمري نحو 15 سنة (1959). في هذه السنّ كنا في المعهد الأنطوني، واقتربت بدايات نزولي الأولى إلى بيروت». ويردف: «تكونت عندي من الأيام التي سكنا فيها في منطقة جبيل، وكوني كنت أقرأ «التأمل» و«رسالة القديس بولس» اضافة إلى مجلة كانت تصدر باسم «القدّيس شربل» وتصل إلى البيت، علاقة وثيقة بالقراءة بالعربية والكتابة بالعربية وبشكل أكثر تفوقاً من الآخرين. ومع الوقت صرتُ أُكثر من عملية قراءة الدروس، ولهذا السبب بدأت مطالعتي باكراً، وقرأتُ كل ما يتوافر لدي بنوع من الشغف، وكانت توجد كتب جميلة تغريك للقراءة. كانت كتب جبران (خليل جبران)، وقراءة جبران كانت تغري الكل وليس أنا وحدي. عندك ميخائيل نعيمة، مارون عبود، ومجموعة من الكتّاب اللبنانيين، ثم اتسع الامر ليشمل إنتاج العالم العربي وخصوصاً الإنتاج المصري. وعندما نزلتُ إلى بيروت، كنت صرت متمكناً من علاقتي بالكتاب. وكنت آخذ النقود من والدي، لأن الأرصفة كانت وخصوصاً نهار الأحد على ساحة البرج، تضع كتباً للبيع، فأشتري بما معي من نقود كتباً وآخذها معي إلى المنزل، ومن هنا بدأت فكرة تأسيس نواة مكتبة». ويستحضر «أول مرة دخلت إلى السينما مثلاً وحضرت فيلماً، خفتُ أن تصيبني رصاصة من الشاشة وصودف أنني كنت أحضر فيلم كاوبوي. لم تركب في رأسي كثيراً أن ثمة عازلاً بيننا وبين مَن يطلق النار اسمه الشاشة، كنت حينها في الرابعة عشرة. وبعدها مرة مرتان ثلاثة حتى اكتشفت الأمر وبعدها مَن يستطيع أن يخرجني من السينما؟ كانت السينما نوعاً من حالة تثقيفية أيضاً جديدة، اذ كان المسرح قليلاً ونادراً، بالإضافة إلى ذلك لم يكن بعد قد بدأ التلفزيون، او كان حضوره قليلاً جداً وكنا نتكل أكثر على الراديو». اليسار والماركسية ويسترجع «الصراع المستديم مع والدي» ويقول: «لم تكن عنده رغبة في أن أكتب، وكل ما كنت أكتبه كان يمزقه، وكل شيء يمزقه كانت أمي تضعه في كيس تحتفظ به وتخبئه لي، حتى صار عمري 19 أو 20 سنة. درّستُ عند الراهبات الأنطونيات في الدكوانة أربع ساعات بالليل، بين السادسة والعاشرة، ما يعني أنني بدأت التدريس وكنت ابن 20 سنة (1964) وأعطيتُ صفوف البكالوريا دروساً في اللغة العربية. في السنة التالية، دخلت إلى المدرسة بشكل طبيعي كأستاذ أعطي الصفوف التكميلية ثم التحقتُ بمدرسة ثانية، ومدرسة ثالثة. وصودف أن الأستاذ الذي كان يعلّمني في البترون ويدعى الدكتور ميشال سليمان كان كذلك أستاذ برهان علوية (المخرج المعروف)، وتعرفت إليه في بيروت بعد أن صرت أنزل إلى العاصمة، وكانت له علاقة مع (الشيخ) عبدالله العلايلي ومع (الأديب) رئيف خوري، فتعرفت إليهما في تلك الفترة اي في البدايات، فكبرت في رأسي القصة، وتفادياً للعودة الى البيت والخوض في شجار مع والدي لأنني أكتب قلتُ في نفسي: يا صبي خذ مكتباً. واستأجرتُ مكتباً إلى جانب مكتب رئيف خوري في بناية «المونو بالاس» ودخلت في جو مجموعة من الأدباء، لأن رئيف خوري كان قطباً يستقطب مجموعة كبيرة من المفكّرين، وتعرفت إلى الشيخ عبدالله العلايلي وصارت علاقتي معه جميلة جداً؛ وبعد فترة صدر ملحق اسمه «جريدة الجريدة»، ولعله أفضل ملحق أدبي صدر حتى اليوم وكان فقط للكتّاب الكبار، وكنا ننتظر نهار الأحد حتى نقرأه. لم يكن على ما هو عليه الحال مع ملاحق اليوم حيث يوجد مسؤول كبير في حين ان مَن يملأ الصفحات فهم الصغار. نحن لم نكن نتجرأ. نكتب النصّ ولا نتجرأ أن نقول لرئيف خوري أو لعبدالله العلايلي أو لميشال سليمان أو للأب مطانيوس منعم. فعلاً كانت مجموعة من الأسماء من الأوائل الذين تعرفت إليهم، أسماء يسارية، وأنا صار عندي ميل لليسارية، لعدة أسباب بينها أن جريمة قتل وقعت مرة في ضيعة في منطقة جبيل، وطلب قائد منطقة جبيل من والدي أن يقبض على القاتل، وإذا لم يقدر فليجمع الطرش (الماعز والأغنام والطيور) في الضيعة ويبدأ بذبح الديوك والدجاج، وإذا لم يسلموا القاتل، يبدأ بذبح الماعز والغنم، وإذا لم يسلموا يبدأ بذبح البقر. أبي رفض هذا القرار فوضعوه في السجن وأنا صرت أزوره في السجن، وما زلتُ أذكر أن الحمّص بطحينة كان طيباً (شهياً) وعلى وجهه لحم وصنوبر، كنتُ آكل أنا وإياه في السجن. تعلقت كثيراً بأبي، ومع الوقت صرت أحس بالنبل في موقفه ضد الظلم؛ بالإضافة إلى مرض أمي وكيفية علاقتنا مع ساحة البرج، اذ كان أبي يأتي بأمي الى طبيب في بيروت، ولم تكن إلا بوسطة واحدة هي التي تأتي، فنضطر إلى أن نستقلّها في الصباح الباكر، وننتظرها حتى تأتي العشية، وأمي جالسة على كرسي، وهي مريضة، وكل العلاج الذي يعطونها إياه كان يزيدها مرضاً اضافة الى عملية انتظارها موعد انطلاق البوسطة إلى الجبل؛ صورتي لساحة البرج كانت صورة حزينة، صورة فيها نوع من إحساس انتقامي. ومن خلال معرفتي برئيف خوري وميشال سليمان دخلت بالماركسية كبداية إطلاع جدي، وقرأتها بشكل واف، ولم أزل حتى اليوم. أنا شخص ماركسي، وبطبيعة الأمر لا أحب أن أنتمي إلى حزب، لأن الحزب لسان طويل، والشاعر أجنحة طويلة، وهناك فرق كبير بين اللسان الطويل ومَن له جناح طويل. الكتاب الأول والإذاعة وعن مرحلة الكتاب الاول والإذاعة يروي: «رحت إلى كلية الحقوق وكلية الآداب. وكنت في عمر 20 أو 21 سنة يوم بدأتُ التعليم، وخطفني العلم، وكان عندي هاجس أنني أريد شراء مكتبة، وأنني أريد الاستقلالية. وطُبع لي أول كتاب العام 1960 وكان اسمه «عذارى الهياكل». ومَن جعلني أطبعه هو رياض حْنَين، وكان محرراً في جريدة «الجريدة»، وكان كذلك الناظر في المعهد الأنطوني. كان يقرأ لي غالبية كتاباتي ويسألني: لماذا لا تطبعها؟ بعدها عرّفني على آل الخليل، في مكتبة الحياة، فطبعوه لي وقتها؛ وعندما رآه والدي مطبوعاً صار يخفي عملية انقلابه المفاجئ نحوي، لكن ظل عنده نوع من الاحساس يقول: لا، إن هذا لا يطعم مصاري (نقوداً) أو خبزاً»، وكلما «دقّ الكوز بالجرة» كان يقول لي: «شو عم تعمل جبران خليل جبران؟ جبران مات من الجوع وجبران كذا وكذا»... وصار عندي هاجس أن أثبت لوالدي أن المكان الذي أنا فيه يقدر أن ينتج نقوداً، ولذلك علّمت في عدة مدارس، وأدخلني رئيف خوري إلى الإذاعة اللبنانية، وقدمت وقتها برنامجا اسمه «مع الغروب» وكان ذلك العام 1967 أو قبل ذلك، لم أعد متذكراً، وكانت في الإذاعة ناهدة فضل الدجاني تقدم برنامج «مع الصباح»، وكنت أكتب يومياً نص «مع الغروب» وأقدّمه بصوتي، وصرت أكتب مادة تكفي لأسبوعين من الشعر لـ «مع الصباح» بصوت ناهدة فضل الدجاني؛ وكان من جملة المشاركين مع هذا البرنامج رفيق خوري، الصحافي في الأنوار (حالياً)». ويضيف: «في احد الأيام، وبشكل مفاجئ، قلت لوالدي: أريد أن أرسل أخي إلى الخارج وأخصصه طبيباً. هنا «طار عقله» ونهرني: تريد إرساله ليكون طبيباً؟ نحن بيت كذا وبيت كذا، وكذا، هل شغلتك أن تجرّصني (تفضحني) في الضيعة، يبن أهلي وأقاربي؟ هذا أخوك يذهب وهو بأول عمره إلى عالم البنات فيه فلتانة (غير منضبطة)، وإذا كان معك قرشان من المال فبعد شهرين أو ثلاثة أكيد سيرجع ولن تستطيع أن تتابع تعليمه، فبلا هذه البهدلة يا بني، وليس لنا علاقة بهذه القصص. لكنني أصررت وقلت له فلنجرّب. وسافر أخي وبدأ يدرس طبيباً، وتابع تحصيله وتخرّج طبيب قلب، لأن أمي كانت مريضة بالقلب. في هذه الفترة، تنامت ثقافتي السياسية وكذلك الاجتماعية، وصار إلى حد ما عملي جيداً، بعيداً عن الحركات الطلابية؛ وكانت عندي باستمرار رغبة في أن أجالس مَن هم أكبر مني، كمفكرين وشعراء. ولم تعد تشبهني الصداقة مع أي شخص من العمر ذاته أو من جيلي ذاته. وبعدما مات رئيف خوري (1967) كرهتُ المكتب، الذي كان بالمونو بالاس، فتركته وانتقلت إلى مكتب بالعازارية، وبعدها أخذت مكتباً في بناية اسمها سيتي سنتر، واندلعت الحرب الأهلية (1975)؛ كنت أدرّس في عينطورة يومها، لأن غالبية المدارس التي علّمت فيها سابقاً، كان أربابها يقولون لي «مع السلامة» على خلفية أفكاري، ولا تزال تلاحقني حتى اليوم هذه القصة بسبب أفكاري، إن كان بالنسبة لجزء من النقاد أو جزء من الشعراء، وهذا موضوع آخر». المكتبة ويتابع: «في برنامج «مع الغروب»، كنت يومياً أكتب قصيدة كلاسيكية، وكانت ممارسة عملية أكثر منها حالة إبداعية. كنت أكتب نصوصاً وأضعها جانباً بسبب صعوبة الطباعة كشعر؛ وكان هناك جو يبني «حرمة» للمستوى الشعري. كنت أشعر بانه إذا أنا نشرتُ كجوزف حرب مَن أكون أمام أمين نخلة مثلاً، أو سعيد عقل أو الأخطل الصغير؟ كان هناك شيء من الخجل وليس مثل اليوم؛ فثمة مَن يكتب النص بالمقلوب ويطبع بالجيد (المستقيم)، وبيمشي الحال. لا، كان هناك نوع من الحرمة التي لا توصف والتي فُقدت، ولسوء الحظ صار البديل عنها الوقاحة التي تشمل ايضاً الطباعة. حتى أتت سنة 1975، وكنت أخذت بيتاً من أجل الزواج. وكما قلتُ كنت أعلّم (أدرس) في عينطورة، واستأجرت البيت في منطقة الضبيّه، فطار البيت علماً انني كنت قد أسست مكتبة مهمة جداً، ساعدني عليها الراحل عبدو مرتضى الحسيني، من منطقة بعلبك، وكانت عندي أقساط شهرية أدفعها في مكتبة أنطوان، ووصلت محتويات مكتبتي إلى نحو 20 أو 22 ألف كتاب، وقتها؛ وحاولتُ أن أعطيها جواً جميلاً وأن تكون زينتي الوحيدة، فضلاً عن أنني جمعت مخطوطات. يعني مثلاً «المجدليّة» بخط سعيد عقل كانت عندي، وأعطاني إياها رئيف خوري؛ وايضاً قصيدة بخط أحمد شوقي، وقصيدة بخط الأخطل الصغير، وقصيدة بخط حافظ إبراهيم، وكنت قد جمعت تقريباً 82 نصاً، على أساس أن أبرْوزها (أضعها في إطار) وأزيّن البيت بها، وكان عندي القسم الإسلامي والقسم اللاهوتي متكاملان كلاهما، اضافة الى قسم التراث، وكنت قد رتبتها للمكتبة، وفجأة طارت كلها. وطار المكتب؛ وكان أهلي ما زالوا في المريجة. المكتب احترق، والظاهر أنه نُهب قبل هذا، والبيت الذي أخذته في ضبية أرسلوا لي رسالة أنه ممنوع عليك أن تأتي إلى هنا. أنا فلّيت (تركت) من المنطقة الشرقية (المسيحية) بعد محاولة اغتيالي. ويوم استأجرت البيت في الضبية لم يكن يخطر ببال أحد أن هناك حرباً آتية، وستتخذ هذا المنحى». ويردف: «على الصعيد الفكري الماركسي، لم أكن (كثيراً) مقبولاً خصوصاً عند حزب الكتائب، فانتقلت إلى منطقة الحمراء في غرب بيروت. في الضبيه طار البيت هناك ونُهبت المكتبة، وكان عندنا بيت في محلة المريجة، وقد ضُرب عام 1982 بالقصف الإسرائيلي. طبعاً كنت قد نقلت أهلي قبل أن يُضرب؛ يعني احترق البيت في المريجة، نُهب المكتب، وصار ممنوعاً عليّ الرجوع إلى الضبية، ومكتبي في السيتي سنتر احترق بسبب قصف «الشباب» (المتقاتلين) من الناحيتين وهو كان على التماس، إلى أن تعرضتُ لمحاولة اعتقال هنا في بيتنا في المعمرية من طرف فلسطيني مشبوه عادة بطبيعة تصرفاته، ثم لمحاولة اغتيال في محلة حرج تابت في بيروت، ومحاولة خطف وقتل في المريجة، ومحاولة اغتيال هنا (الجنوب) عند مفرق مغدوشة. وعندما تعود لتفكر في كل هذه الأمور مجتمعة تجدها حالة طبيعية؛ أن تتعرض لهكذا أمور بسبب الوضع الذي كان قائماً وكيف كانت الأطراف منغمسة في قتال كان مرات كثيرة عبثياً لأن الهدف الأساسي الذي كانوا يقاتلون في سبيله مقفل وغير صحيح. هم مارسوا أمراً آخر. ربما كانت محاولة خاصة صارت معي في محلّة الحمراء، اذ ضربوني بشلف (قضيب) حديدي، بآلة حادة على رأسي ووقعت على الأرض وبقيت نحو 4 ساعات، بالقرب من سكني، وهي منطقة مظلمة ومقفرة، بين 1979 أو 1980». ويروي انه «سنة 1986 طبعت أول ديوان شعري اسمه «شجرة الأكاسيا». ويومها اتصلوا بي من دار الفارابي، ليسألوا: إذا كان عندك نص شعري نحب أن نطبعه، فأعطيتهم شجرة الأكاسيا. وبعد عشرين سنة في 2006 طبعت «المحبرة» من نحو 1750 صفحة؛ ولعله الديوان الأكبر في التراث العربي. علماً انه العام 1998 صرت رئيس اتحاد الكتّاب اللبنانيين. حالياً لا أحب أن يُسرق وقتي؛ منذ البداية عندي إحساس أن وقتي قليل. عندما تكبر قليلاً بالعمر يزيد هذا الإحساس ويصير عندك خوف أن ينسرق جزء من وقتك ويتصرف الآخرون به مثلما هم يريدون، لآن الآخرين لا يكتفون بأن يتصرفوا بك، بطبيعة عملك أو طبيعة تفكيرك، بل يتصرفون كذلك في وقتك ويصرفونه على كيفهم. فابتعدت قليلاً عن بيروت. عندي شغل فكري وشغل وطني، إنما في بيت اسمه «الظل» وأنا ساكن في الظل وجميل أن تسكن في الظل إذا كانت الحرارة في الخارج شديدة لا تحتمل. انا أكتب ولدي نوع من الشعور بأنني هكذا لا أكون قد أضعت وقتي في ظل أمور البلد التي لم تعد هادئة». ويضيف: «في بيروت، لا يمكن أن تمارس حريتك في التحكم بوقتك وفق ما تشتهيه، فنمط الحياة في العاصمة صار أقرب إلى أن تعطي وقتك لغيرك من دون جدوى، بدل أن تقدم وقتك لنفسك بشيء مفيد. وأتصور أن أي تواجد مع الآخرين اليوم خارج مفهوم الوظيفة فيه نوع من إضاعة الوقت كبير جداً؛ وأنا لا أتعاطى هنا مع بيروت من موقع لا يصح. وإنما بيروت، في ظل الحراك الموجود فيها والوضع الموجود فيها والآمال المنتظرة فيها، لا تقدر أن تقدم لي نموذجاً بشرياً يمكن أن أتعاطى معه، ولا وقتاً يمكن أن أعطيه لنفسي بشكل طبيعي وهادئ، ولا علاقات لي رغبة في أن أضعها كفواصل بين كتابة وكتابة، وتكون شيئاً مريحاً لي. أنا إنسان بعيد جداً عن المقاهي التي كانت تعني لي عندما كان يأتي إليها أمين نخلة ورئيف خوري وسعيد عقل وأجلس معهم وأنا صغير في العمر، وكان هذا يعطيني نوعاً من الرضى كوني كنتُ أصغي بشكل جميل وشكل جيد، وكنت أتمتع بهذه النعمة ولم أزل أتمتع بها، فأنا إنسان أحب الإصغاء؛ هذه الأمور لم تعد موجودة، ويمكن لفنجان القهوة أن يأخذوه عن الطاولة ويخرجوا الصرصور من الركوة ثم يصبّون لك في الفنجان عينه، ويأتون إليك به على اساس أنه أُعدّ خصيصاً لك، منذ قليل. صار رواد المقاهي كثرا و«يا محلا الصراصير بالفناجين». فيروز وزياد وعن مرحلة التعاون مع الرحابنة يروي: «زياد (الرحباني) تعرفت إليه في الإذاعة اللبنانية عندما ترك المنطقة الشرقية، وتعرفت إلى السيدة فيروز من خلال زياد، ومن ثم الأغنيات التي لحّن زياد جزءاً منها. أول أغنية والتي كانت سبب معرفتي بالسيدة فيروز هي «حبيتك تا نسيت النوم». وكان الأخوان الرحباني قد أعطيا زياد ست أغنيات كي يلحنها من أجل برنامج كانا يعرضانه في الأردن، فقال أنا ألحّن لكم 6 اغنيات إذا كتب الكلمات جوزف، فكتبتُ 6 أغنيات ومن جملتها «حبيتك تا نسيت النوم». وعندما «طلع» اللحن مع زياد، ركنه جانباً (تركه إلى حين) وقال: أريد أن أعطيه لفيروز. أسمَعه إلى فيروز فأعجبها اللحن وكانت هذه البداية، وغنت أكثر من 16 أغنية (من كلماتي) بالإضافة إلى تراتيل لها علاقة برأس السنة والميلاد. زياد مرّ وقت طويل من دون أن أراه، وأنا مشتاق له فعلاً؛ كان البلد شيئاً آخر لو لم يكن زياد موجوداً. تقريباً ساهم في إنقاذ أرواحنا كلنا، في المسرح والموسيقى اللذين قدمهما. وفيروز والأخوان الرحباني لعبوا هذا الدور؛ لكن كعلاقة مباشرة، زياد لعب دوراً مهماً؛ هو لا يحب الكلام عنه، ويعتبر أن التفخيم به نوع من التفنيص (الرياء) لكن لا، زياد أعطانا شيئاً من التوازن والقدرة على الاحتمال». وعن علاقاته العربية يقول: «الصيت لسورية والفعل لمصر. أنا علاقاتي بمصر أكثر من سورية، وعلاقتي بالأردن أكثر من مصر. والتركيز على سورية لسبب واضح تماماً وهو تركيز سياسي، في حين ان علاقاتي سواء في المغرب العربي كله او مصر او الاردن او سورية وصولاً إلى أرز الأطلسي كما يقولون، محترمة كثيرة وجميلة جداً وبعيدة قليلاً عن طابعها الإعلامي لأن هناك كثراً أذوا من مثل هذه العلاقات. اذ حين يدعونهم إلى مصر أو المغرب أو الإمارات او الكويت أو الأردن أو أي بلد عربي، تشعر بأن حضورهم أحياناً إهانة للفن والفكر اللبناني، لأن طبيعة مسلكهم وتصرفاتهم لا توحي إلا بحرمان وفجع غرائزي لا يطاق. انا أولاً لا أواكب هؤلاء الجماعات الذين يذهبون في هذه الحالة، وثانياً لي موقعي الخاص عند الكل بالإضافة إلى سورية التي أنا مقتنع تماماً برأي سعيد تقي الدين «أن بين سورية ولبنان واو كافرة». والشيء الجميل أنني ضمن إطار طبيعة حياتي، لا أطلب إلا كتابة النصّ ولا أريد شيئاً آخر. تتسع وتكثر علاقاتك بالنسبة للعالم العربي، وتشعر بأن لك إقامات وهجرات جميلة ولك أصوات تأتي أحياناً من خلال الهاتف وتجلس معها وتشعر بطراوة الزمن. ورغم علاقات الغياب التي تكون داخل هذا الزمن هناك شيء يخفف ويساعد أكثر من العلاقة اليومية المباشرة في بيروت». وعن والديْه يقول: «أبي تربّى يتيماً، وأخذ (تزوج) بنتاً والدها إقطاعي كبير سافر الى اميركا مرتين وأحضر معه مالاً كثيراً واشترى أرضاً طويلة عريضة، والشيء الرائع في والدي أنه لم يغره اي شيء، من إرث جدي، والد أمي؛ والشيء الرائع بأمي أنها اكتفت بفقر والدي، ما أخذت شيئاً من أهلها، ومرات كثيرة (في أحيان كثيرة) عندما نكون على طبق نأكله، كانت أمي تنتظر حتى نشبع ثم تأكل؛ مع أنها كانت تقدر أن تذبح بظفرها. الشيء المؤلم جداً أنها كانت لم تزل تخبئ الأوراق التي كان يمزّقها أبي عن كتاباتي في خزانتها، ولكن احترق البيت في المريجة واحترق كل شيء... المكتب، الصور والشهادات التي لي، وكل ما أملكه كذكريات وكوثائق رسمية وغير رسمية. «فحّم» البيت كله، طار الكيس وراح؛ قيمة الكيس أمك، لا قيمة أدبية له، يمكن أن يكون تافها، لكنها ساهمت في صناعة هذا الشخص أكثر من أي إنسان آخر». وعن المردود المالي الذي أمّن له الاكتفاء في حياته يروي: «درّستُ لفترة 10 سنوات، وهذه ليست فترة طويلة، ودخلت في البرامج الإذاعية، هنا وفي الخارج، وكتبتُ للتلفزيون نحو 25 مسلسلاً؛ وأنا منحسر عما يسمونه الشهرة وهذه التي يسمونها النجومية في الحضور اليومي والجرائد والتلفزيونات. فكلها لا تعني لي شيئاً. أنا الذي حصّلته حصّلته وأعطاني شيئاً من الراحة المادية هو الجهد الإذاعي، لأنني كنت أكتب لما لا يقل عن 6 محطات إذاعية في الخارج، وكان لها وكلاء هنا، وكانوا يأتون بأفكار برامج مصدق عليها من الإذاعات، مثلاً من الكويت، وأنت تكون مقدماً فكرة 4 أو 5 برامج، وهؤلاء الذين تعاطوا كوكلاء مع الإذاعات العربية كان يأتون بموافقة عليها، فتكتب أنت النص الذي تتلقى عليه بدلك؛ البدل الذي كان يُدفع من الخارج كان محترماً وليس كالذي في لبنان؛ والنص التلفزيوني عندي أراحني كثيراً، وكما قلتُ وضعتُ نصوصاً لـ 25 مسلسلاً وهذا ليس قليلاً؛ من جملتها «رماد وملح» و«أوراق الزمن المرّ» و«قريش» و»امرؤ القيس» و«قالت العرب» و«أواخر الأيام» ؛ وهذه شكلت لي نوعاً من مردود كان جميلاً، لكن، دائماً كان هناك صراع بيني وبين والدي، حتى أجعله مطمئناً الى أن هذا الوضع يطعم أكثر من الخبز، ويعطي راحة حياتية أفضل. وكثير من النقود التي حصّلتُها كنت أعطيه إياها وأقول له «دعها معك»، حتى يشعر ضمناً بأنه من خلال النقود التي معه وهي من ابنه، أن نجله يجني المال في المكان الذي يعمل فيه. وكأنني كنتُ أقول له شكراً وكثّر الله خيرك، وأحاول إخماد الهاجس الذي كان يحرقه بان يعيش أولاده من دون العذاب الذي عاناه هو في حياته، فأعطيته بذلك شيئاً من الطمأنينة». وحين يُسأل عن «طقوس» الكتابة يقول: «أنا إنسان أجلس خلف الطاولة عندما أستيقظ. وكوني بعيدا عن أجواء العلاقات، أظلّ خلف الطاولة. أنا منذ فترة غير قليلة هكذا، لأنني لم أتوظف ولم تكن عندي وظيفة ملزم أن أذهب إليها في وقت معين؛ كنتُ خارج هذا الأمر وكل الوقت للجلوس وراء الطاولة؛ لكن متى يركب معك النص؟ لا أحد يعرف، يمكن أن تجلس أسبوعاً، وربما يتطلب الامر 12 ساعة من 24 ساعة أو أكثر ويمر أسبوع ولا يطلع معك شيء؛ يجب أن يسيطر عليك الزمن الفكري وليس الزمن العادي؛ الزمن اليومي لا يمكن أن تربطه إطلاقاً بالزمن الفني، هذا الزمن الإبداعي لا تعرف متى يأتي، لا تعرف إن كان سيطول حضوره، لا تعرف إذا كان سيمحي أو يقصر، ومرات تشعر بأنك أنت مرهق لدرجة لست قادراً أن تجلس وراء الطاولة ولا على استيلاد اي شيء. الكتابة هي عملية صلب، وإنما عندما تنتهي من وضع النص لا تدري كيف تأتي هذه الراحة. على فكرة، آرنست فيشير عنده كلمة جميلة جداً: «الفن هو أرقى متعة تهبها إلى نفسك؛ تقدمها كهدية لك أنت»، لا يوجد أوقات محددة، كل وقتي أنا، أعطيه للكتابة». ويضيف: «بعد الكتابة، يمكن القول ان التصحيح مصيبة. في الماضي، الذين كانوا يصفّون الحروف في المطابع كانوا يفهمون بالصرف وبالنحو، بجمالية الكتابة؛ كان التحريك عندهم سهلاً جداً، اليوم تعطي كتابك ليصححونه فيضعونه أمامهم، وبين سيكارة وردّ على الخلوي، وبين العلكة وبين أنه ينتظر بصبر وقت الصرف، وأتوا به ليقرأ العربية من الشمال إلى اليمين، وليس من اليمين إلى الشمال، يضيع نصك ويضيع كتابك، ويُطبع كتابك الذي تكون تعبتَ عليه تعباً طويلاً عريضاً، وفيه أخطاء لها أول وليس لها آخر. تغيّرتْ الأيام كثيراً وتغيّرت بتطور علمي من حيث الأدوات، وإنما بتخلّف فكري. هناك تخلف فكري كبر في عملية المطبعة». ويتابع: «انا أطبع ديوانين سيصدران قريباً، واحد بالمحكية وواحد بالفصحى؛ الذي بالفصحى «أجمل ما في الأرض أن أبقى عليها»، طويل العنوان؛ والمحكي عنوانه «زرتك قصب فلّيت ناي» عن دار الريس؛ ودلالته أن واحداً أتى لعند الآخر، فالتقاه من دون عواطف، وفجأة تركا بعضهما وأجمل ما فيهما عواطفهما. كأن أحدهما اشتغل على الثاني وحوّله من قصبة إلى ناي». وهل هو نادم على شيء؟ يجيب: «لست نادما على شيء، لا يوجد ندم، هناك شيء من القرف، وانتَ ملزم بأن تتماسك. لن أسمح لأحد بأن يتعاطى مع وقتي، من زمني الشخصي. التعويض بالكتابة، أما خارج هذا فالخسارات كبيرة، لكن عندك نوع من الاحترام للآخرين؛ هناك آخرون دفعوا أثماناً أكثر من الثمن الذي دفعتَه أنت. الذي راح (خسر) ابنه أو قُتل هو أو تشرّد تعرّض لما هو أقسى بكثير مما حصل لك أنت في هذه الحالة». لكلّ شاعر «ملهمه»، فما مصدر إلهام جوزف حرب؟ يجيب: «أكثر شيء أحببته هو اللغة العربية وقراءتي للتراث. هناك غنى فني رائع جداً فيهما، وكلما تضايقت، هناك كتب الإنشاء العربي فيها رائع جداً، فأنصرف لقراءتها». والحبيبة؟ يجيب: “الزمن الإبداعي غير الزمن العادي؛ الزمن العادي ان تتعرف على امرأة الآن، ويمكن بعد 30 سنة ان تولد قصيدتها؛ لا أحد يعرف، ليست العلاقة التي تنتج القصيدة. في الزمن الداخلي هناك اختمار في اللاوعي للأشياء لا يمكنك أن تقرره. ربما يمكنك أن تجلس خلف طاولة، وتقرر أن تكتب نصاً عن فلان، وقد يخرج نص جميل عن حبيبة مثلاً، لكن الكتابة «الجبرية» (الاضطرارية) لا تحمل الجمالية الطبيعية للنص الذي يولد من دون ضغط الوقت والاضطرار. قد تكتب نصاً عن هذا الشخص أو هذه الحبيبة أو الذي بينك وبينه علاقة؛ ليس هناك تلازم بين ما هو خارج وما هو داخل إلا بشكل انقلابي. وربما ما هو «خارج» حدَثٌ جرى مثلاً سنة 1970 ولكنه الآن التقى مع ما هو «داخل». ربما ما هو «خارج» اليوم قد يلتقي مع الزمن الداخلي بعد عشر سنوات؛ وإذا كان الواحد عمره أكبر، ربما لن يأتي وقته؛ ربما يفل (يرحل) قبل أن يأتي هذا الوقت؛ باختصار لا يمكنك أن تتعاطى مع النصّ بقرار إطلاقاً؛ النص زمنه الإبداعي يحتاج لأن تُخضع له الزمن العادي، وحين تقرأ النص وتحس أنه يملك، جمالياً، زمنه الفني، تفرغه مما تسمّيه الزمن العادي. لهذا، أنا مرات كثيرة ضد فكرة الأجيال وضد فكرة أنه الآن هناك ظاهرة وموجة، وبعد فترة موجة، الآن جيل ثم جيل ثان، وجيل ثالث. ربما هناك نص من نصوص أبو حيان التوحيدي حتى اليوم لم ينتهِ الواحد كناقد من عملية دراسته. بمعنى ان الزمن الفني يلغي كل الأزمنة العادية، وتختلط هذه الأزمنة العادية من خلال النقاد الذين يقسمون الزمن الفني على مقياسها هي، وتختلط مع بعضها لدرجة أنها في الآخر ستخضع لما يسمى الزمن الفني، وإلا ليس هناك من فنّ». ويضيف: «ربما ما كتبته اليوم سيكون نصاً إبداعياً في زمن آخر، وربما بعد عشر سنوات؛ أو ربما ما تكتبه في عمر 30 سنة لا يمكن أن تكتبه في كل العمر الباقي؛ هناك أسئلة بالفن لم تتوافر أجوبة عنها، لدرجة أنه على قدر ما هنالك من بلاهة وغباء عند كثر من النقاد أو المتطفلين على النقد، يتنازعون ليضعوا نوعاً من النظريات بحسب تجاربهم هم، أو تكون سبباً لإعطاء نفوسهم إضافة فنية ليست موجودة فيها؛ من هنا الكتابة حالة صلب، لا تعرف كيف ينزلونك عن هذا الصليب، وكيف تكون ساعتئذ؛ مرات كثيرة تدخل إلى السرير وتقول هذه آخر ليلة، خلص (أنه) لن أعي ثانية، وربما تدخل إلى السرير ليس في الليل بل عند السادسة مساء، وكنت لمّا تزل من الليلة السابقة وأنت خلف مكتبك، وعندما تعي (تستيقظ) تقول الآن سأدخل إلى السرير. يعني تدخل إلى السرير وعندك إحساس أنك لن تنهض، وحين تستيقظ وتريد أن تخرج من السرير تقول يا ريت لو أنني أستطيع أن أدخل الآن وأنام، على قدر ما يكون الواحد مرهقاً؛ وفجأة يخطر على بالك شيء ويطير كل هذا الإحساس، اي لا يعود قائماً ولا تعود تفكر هكذا، هناك نوع من خضوع، وهو خضوع جميل. أو أن هناك نوعاً من الاجتذاب، يعطيك نوعاً من التوازن، بين تعبك جسدياً وبين راحتك فكرياً؛ وإنما عندما تزول هذه الراحة الفكرية، تكتشف أنك محطّم». ويتابع: «المحبرة» الذي هو أضخم عمل، البعض تمسخروا عليه (سخروا)، وأنا أهديه للموت، لأنني أعتقد أن أهمّ محرك لكل شيء هو هاجس الموت، فأنت يمكنك أن تبقى سنة من دون طعام، إذا كنت متيقناً أنك لن تموت. دائماً محركك هو الخوف من أن يصيبك شيء، والإصابة الكبرى هي الموت. وراء مطلق أي حركة وعظمة الحياة بحد ذاتها، هو هاجس الموت. وأنا قبل أن أفكر بكل هذه الأمور من البداية قلت لك انه منذ زمن طويل يراودني إحساس بأنه لم يتبق لي وقت؛ منذ كنت طفلاً وهذا الإحساس يتملكني. لكن، طبيعة التعاطي، ربما لأنه عندك فوران فكري وأنت بحاجة إلى وقت أكثر، أو تحس عندما توازِن بين الزمن العادي وبين هذا الفوران الفكري، تخاف أنه ربما يكون هذا الفوران بحاجة إلى وقت أطول. أنا وقعتُ في تحدٍّ ربما هو الذي وضع هذا الإحساس فيّ؛ أنني كتبت نصوصاً شعرية كاملة وليس مجموعة قصائد، يعني، «شجرة الأكاسيا» عمل شعري كامل، من أوله لآخره. «مملكة الخبز والورد» عمل كامل. «المحبرة» عمل كامل، «السيدة البيضاء في شهوتها الكحلية» كذلك عمل كامل. هذه أربعة أعمال، إنجازها الشعري في آخر صفحة فيها، هي مقسّمة كمشاهد ومقاطع في الداخل، وإنما هي عمل واحد. هنا، عندما تبدأ بعمل وعندك هذا الهاجس، لا يعطيك هاجساً أنك تكتب قصيدة «زغيروة» (صغيرة) ويكون في بالك انه «بكرا بنخلص وبعد بكرا بنخلص» (غداً تنتهي وبعد غد تنتهي)، بل أنت تدخل في زمن ربما يأخذ معك نحو 5 أو 6 سنوات فتقع في هاجس الموت، بمعنى أنه ربما انا لن أنهي هذا النصّ «قبل ما فلّ» (أموت). ستقع في هذا الهاجس دون أن تضعه عاملاً يخفف من قيمتك الجمالية، بل يجب أن يعطيك نوعاً من شحنة كثيرة لتكون جماليتك أهم، مع ما يتبع ذلك من هاجس أنه ربما لن يكون عندك عمر لأن تتمم هذا النص». ويختم جوزف حرب: «هو قهر جسدي، الكتابة قهر جسدي، صلب. لستُ أنا لوحدي، ربما الأمر كذلك عند الكل ولم يعبّروا عن ذلك. ربما طرقهم مختلفة، لكن أنا مثلاً، احترامي كبير لأدباء النهضة فهم لم يتركوا دقيقة إلا واشتغلوا عليها؛ أعطوا كمية عبر أعمار قصيرة، كمية ضخمة جداً جداً ونوعيتها مهمة كثيراً؛ اما الآن فلا أعرف ماذا يحصل». المصدر : جريدة الراي
|
| |  |
 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
لجسده, مع, لقاء, المرض, النجوم, بداية, تحدث, روائع, عليه, في, فيروز, إشارات, نادر, وظهور, وفاته, «غزو», قبل, كاتب  |
« الموضوع السابق
|
الموضوع التالي »
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| انواع عرض الموضوع |
 العرض العادي العرض العادي |
 الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض المتطور |
 الانتقال إلى العرض الشجري الانتقال إلى العرض الشجري |
|
|
 المواضيع المتشابهه
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| لقاء تلفزيوني نادر للكبير ( سعد الفرج ) .. | بحر الحب | الـقاعـة الـكـبرى ( الفن والإعلام ) | 12 | 04-09-2015 10:43 PM |
| لقاء نادر مع الفنانة القديرة حياة الفهد ( 1987 م ) .. | نـواف | الـقاعـة الـكـبرى ( الفن والإعلام ) | 10 | 26-12-2012 07:32 PM |
| لقاء نادر مع الراحل الكبير عبدالعزيز النمش (رحمه الله) | بو عبدالله | الـقاعـة الـكـبرى ( الفن والإعلام ) | 22 | 21-10-2010 12:12 PM |
| فنان مغمور يفصل النجوم المؤسسين لمسرح الخليج . بحجة يريد تنظيفه من الناس !! | محمد العيدان | أكبر أرشيف للمواضيع الفنية الكبرى بالإنترنت | 413 | 18-05-2010 12:27 AM |
| لقاء نادر لسندرلا الخليج ( سعاد عبدالله ) مع الملحن ( احمد باقر ) و (عاليه حسين) ! | وهج الامس | سعاد عبدالله | 3 | 03-07-2009 05:39 AM |
الساعة الآن 08:49 AM